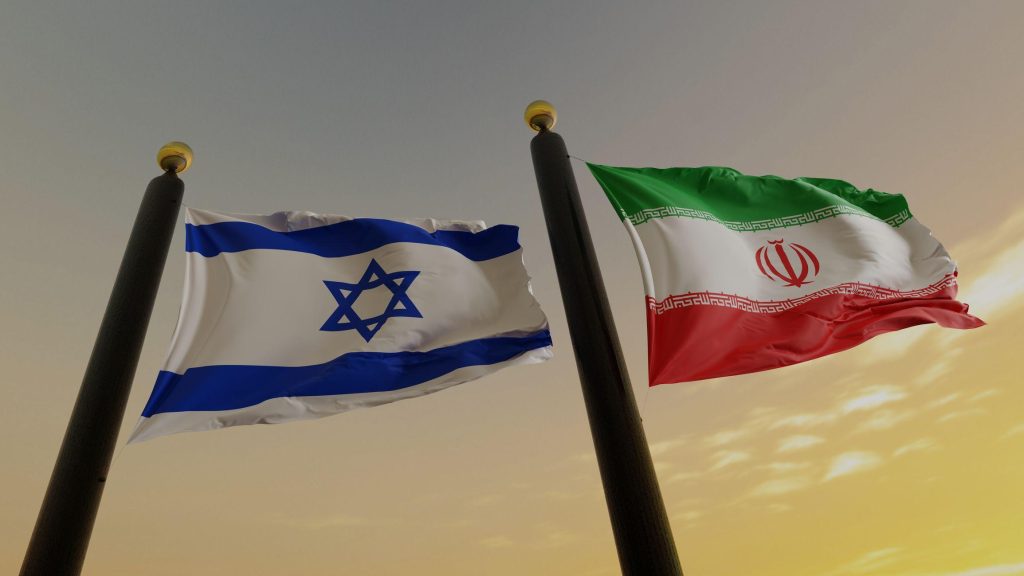منذ الثورة الإيرانية عام 1979، تبنّت إيران استراتيجية الصبر الاستراتيجي والحرب غير المتناظرة (حروب الظل والوكلاء) ضد إسرائيل، وفي المقابل، حرصت إسرائيل على استخدام قوتها الجوية والاستخباراتية لإحتواء التهديد الإيراني عبر عمليات محددة، دون الدخول في مواجهة مباشرة، إلا أن العمليات العسكرية التي انطلقت في 13 يونيو 2025، إثر ضربة إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية ومراكز قيادة داخل إيران، أطلقت سلسلة ردود فعل إيرانية مباشرة، شملت مئات الصواريخ والمسيّرات، موجّهة نحو العمق الإسرائيلي.
جاءت هذه المواجهة لتكشف عن تحولات عميقة في مفاهيم الحرب والردع، وفتحت الباب أمام نمط جديد من الصراع يتجاوز معادلات الردع الكلاسيكي التي حكمت العلاقات الإقليمية والدولية منذ نهاية الحرب الباردة، والتى ارتكزت طوال العقود الماضية على التوازن في القوة أو التهديد بالتدمير المتبادل، إلا أن ما حدث في حرب يونيو الأخيرة قد كشف عن نمط جديد من الردع يعتمد على احداث تكلفة استراتيجية ونفسية مرتفعة، دون الحاجة إلى امتلاك تفوق عسكري تقليدي.
التحوّل في مفهوم الردع:
يُعد الردع من المفاهيم الأساسية في إدارة التفاعلات الصراعية الدولية، وعلى الرغم من تعدد المفاهيم حول نظرية الردع، فإن جميعها قد اتفق على أن الردع هو استغلال القوة المحتملة واقناع عدو محتمل أن يتجنب القيام بنشاطات معينة نظرًا لتضرر مصالحه، حيث يرتكز على تهديد الخصم بالخسائر التي قد تلحق به إذا ما أقدم على القيام بأْعمال تضر أمن الدولة الرادعة، فقد تلجأ الأخيرة إلى عدة أساليب لإثناء الخصم عن التسبب بحرب أو حتى تهديد مصالحها، من خلال التهديد باستخدام أحد من الأساليب التالية (القوة العسكرية، والضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، وتحالفات مع دول أخرى).
ولضمان نجاح الردع يجب توفر ثلاثة عوامل:
- المصداقية: يعتمد الردع الفعال على المصداقية، أي أن الطرف الرادع يجب أن يُظهر بشكل مقنع قدرته واستعداده للرد، فبدونها قد يفترض الخصم أنه قادر على التصرف دون عواقب[1].
- القدرة: يتطلب الردع إمتلاك الدولة لقدرات عسكرية كافية للرد بحزم على أي تهديد، ويعتمد على قدرة الدولة على توجيه ضربة انتقامية[2].
- التواصل والإدراك: يجب أن يدرك العدو المحتمل بنية الردع بوضوح، ويمكن أن يتخذ هذا التواصل شكل تصريحات عامة، أو تدريبات عسكرية، أو إلتزامات تحالفية تشير إلى نوايا دفاعية.
فيما تتعدد أنواع الردع، وذلك كما يلي[3]:
- الردع العام مقابل الردع الفوري: يُشير الردع العام إلى الجهود والإجراءات طويلة المدى لمنع أي أعمال عدائية، بينما يُستخدم الردع الفوري في حالات التهديدات المباشرة والعاجلة، ويؤكد النوعان على نفس المبادئ الأساسية، لكنهما يختلفان في مدى إلحاح التهديدات وتفاصيل إدارتها.
- الردع النووي: يُركز الردع النووي تحديدًا على استخدام الأسلحة النووية لمنع العدوان، ويُجسّد مبدأ التدمير المتبادل المؤكد (MAD) هذا النوع من الردع، إذ يفترض أن أي هجوم نووي سيؤدي إلى رد انتقامي مضمون ومدمر من جانب الدولة المعتدى عليها، مما يردع الضربات الأولى.
- الردع الممتد: ينطوي الردع الممتد على التزام الدولة بالدفاع عن حلفائها، وليس فقط عن نفسها، على سبيل المثال، تضمن الولايات المتحدة ردعًا ممتدًا لأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتُشير إلى أن أي عدوان على أي عضو سيؤدي إلى رد عسكري موحد.
- الردع غير المتوازن: هو شكل من أشكال الردع تستخدمه الدول / الجهات الأضعف عسكريًا أو تكنولوجيًا في مواجهة خصم أقوى، عبر استخدام أدوات غير تقليدية أو غير متناظرة / أساليب غير نظامية (الضربات الصاروخية المحددة، وحروب العصابات، والوكلاء، ووسائل التسلح التكنولوجية البسيطة من أبرزها المسيّرات، والهجمات سيبرانية، والإرهاب، والحرب النفسية، وغيرها) بهدف إيصال كلفة غير متوقعة وغير مقبولة للطرف الأقوى تجعله يعيد التفكير في التصعيد[4].
الردع الإسرائيلي في مواجهة الردع الإيراني:
ارتكزت العقيدة الأمنية الإسرائيلية منذ نشأتها على ترسيخ مفهوم الردع (الردع التقليدي) لتحقيق أهدافها أو الحفاظ على وجودها ومصالحها من خلال العمل على امتلاك القدرات العسكرية والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي (وليس الكمي) والتكنولوجي بالمنطقة سواء بالوسائل الدفاعية (منظومات دفاعية متعددة الطبقات) أو الهجومية (قدرات جوية متقدمة قادرة على اختراق المنظومات الدفاعية المعادية وإحداث خسائر جسيمة في البنية العسكرية والأساسية للخصوم)، إضافةً إلى الردع الممتد والمتمثل في التزام الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية بالدفاع عن إسرائيل.
عملت إسرائيل على تنفيذ مفهوم الردع خلال إدارة صراعتها بالمنطقة عبر مسارين، الأول الردع بالمنع ويُستخدم عادة تجاه الدول المعادية طبقًا لحسابات تلك الدول ومصالحها الاستراتيجية (استقرار نظام الحكم، والبنية التحتية للدولة، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها، وغيرها)، أما الثاني فهو الردع بالعقاب، وتم استخدامه في العديد من المواقف مع القوى الفاعلة من غير الدول (الفصائل الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحوثيين باليمن) والتي تختلف حساباتها الاستراتيجية عن حسابات الدول، كما أن لكل من المسارين مهمة تتحدد وفقًا للظروف الموضوعية وقدرات الخصم وقد يتم الجمع بينهما.
أما على الجانب الإيراني، فقد خاضت منذ نجاح الثورة الإسلامية في عام 1979 حربًا مع العراق عام 1980 واستمرت لمدة 8 سنوات، استنزفت جزءًا كبيرًا من قدراتها الاقتصادية والعسكرية، ثم تلى ذلك توالي فرض العقوبات الغربية العسكرية والاقتصادية عليها مما دفعها إلى الاعتماد على الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير قاعدة صناعات عسكرية محلية (منظومات دفاع جوى، وصواريخ، وذخائر، وطائرات بدون طيار، ..)، كما اعتمدت أيضًا في إدارة صراعها مع القوى الإقليمية (خاصةً إسرائيل) والقوى الغربية على الردع غير المتماثل (غير المتوازن) والذي يقوم على توظيف وكلائها بالمنطقة وامتلاك قدرات عسكرية غير نمطية وقليلة التكلفة (صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة) قادرة على إحداث خسائر في عمق أراضي الخصوم وبما يزيد من تكلفة تورطهم في الصراع.
وخلال الحرب الأخيرة، وعلى الرغم من نجاح إسرائيل في توجيه ضربة استباقية قوية ومفاجئة استهدفت خلالها مراكز القيادة والسيطرة واغتيال قيادات الصف الأول العسكرية وبعض منشآت البنية التحتية العسكرية والنووية باستخدام قدراتها العسكرية والتكنولوجية المتقدمة خاصة القدرات الجوية والعمليات الاستخبارية، فإن ذلك لم يؤد إلى ردع إيران، حيث قامت بتوجيه ردًا قويًا تجاه العمق الإسرائيلي (الردع غير المتماثل) نتيجة لقدرتها على استيعاب الضربات الإسرائيلية، مما دفع الجانبين على تقبل وقف إطلاق النار كنتيجة لما يلي:
- التنظيم الجيد والمؤسسي لأجهزة الدولة خاصةً العسكرية والأمنية (نجاح قيادات الصف الثاني في تولى المسئولية، واحتواء الاختراق الأمني خلال فترة قصيرة).
- إتساع مساحة الدولة وتوظيف ذلك في التوزيع الجيد لقدراتها العسكرية وبنيتها التحتية مما مثل صعوبة على القدرات الجوية الإسرائيلية في توجيه ضربات حاسمة تحد من قدرات إيران على الرد.
- قدرة الجبهة الداخلية الإيرانية على الصمود والاصطفاف خلف نظام الحكم على الرغم من رهان إسرائيل على دفع الداخل للخروج على نظام الحكم.
- نجاح إيران في تنظيم واستخدام المتوفر من قدراتها العسكرية (صواريخ، وطائرات مسيرة) واتباع تكتيك الإغراق والتشبع لإختراق منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات (داخل إسرائيل وخارجها عبر الدول الداعمة لها)، مع عدم الاستخدام العشوائي والمفرط لقدراتها الصاروخية (الاستعداد لمواصلة أعمال القتال لأطول فترة ممكنة) مما تسبب في إحداث خسائر في العمق الإسرائيلي، شملت البنية التحتية العسكرية والاقتصادية.
- صغر مساحة إسرائيل ومحدودية قدرة الجبهة الداخلية على الصمود، ويتمثل ذلك في توزيع البنية التحتية الاقتصادية والعسكرية بالإضافة للتوزيع الديموجرافى للمواطنين على مساحة محدودة من الأراضي، مما أحدث تأثيرًا نفسيًا سلبيًا على السكان، وزيادة تكلفة الحرب على إسرائيل، مما قلص من قدرة إسرائيل على تقييد نطاق الصراع والتحكم في شدته.
- التدخل الأمريكي المباشر في العمليات إلى جانب إسرائيل من خلال القيام بضربة جوية سريعة للمنشآت النووية، مما وفر مبررات للتوصل لوقف إطلاق النار (تحقيق ظاهري لأهداف الحرب الإسرائيلية “القضاء على القدرات النووية الإيرانية إسرائيل”، وردع النظام الإيراني نتيجة التدخل العسكري الأمريكي المباشر).
التحول في مفهوم الحرب:
مثلت الحرب بين الجانبين تجسيدًا متكاملًا لمفهوم الحرب الهجينة أو الحرب المركبة، وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه عالميًا لها، فإن الغالبية تتفق على أنها تنطوي على تفاعل أو دمج أدوات القوة التقليدية وغير التقليدية وأدوات التخريب، حيث تُمزج هذه الأدوات بطريقة متزامنة لاستغلال نقاط ضعف الخصم وتحقيق تأثيرات تآزرية (الآثار التفاعلية المتعاضدة “تأثير تفاعل عنصرين أو أكثر معًا أكبر من مجموع تأثير كل عنصر بمفرده”)[5].
وقد برز ذلك الأمر بوضوح خلال الضربة الاستباقية الإسرائيلية والتي تم خلالها استخدام مزيجًا من القوة التقليدية (تنفيذ هجمات جوية) بالتزامن مع الاستخدام الموسع للقدرات غير التقليدية، مثل:
- عمليات استخباراتية وتجنيد عملاء لتنفيذ عمليات على الأرض داخل إيران عبر الطائرات المُسيرة لاستهداف منظومات الدفاع الجوي ومراكز القيادة والسيطرة وإغتيال القيادات العسكرية وخبراء البرنامج النووي.
- تنفيذ هجمات سيبرانية وإلكترونية أدت إلى تعطيل منصات القيادة والسيطرة وشبكات الدفاع الجوي الإيراني قبل وأثناء القصف بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الإيرانية أثرت على البنوك، والصرافات الآلية، والخدمات الإلكترونية الحكومية، ومنشآت الطاقة، ووسائل الإعلام، ومحطات الوقود ما دفع الحكومة الإيرانية لفرض قيود مشددة على الإنترنت.
- حرب إعلامية، حيث تم اختراق هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وبُثت رسائل تحريضية تدعو للاحتجاج، وانتشرت مقاطع فيديو معارضة على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حملة رقمية مركّزة، تستهدف مجموعات سكانية معينة برسائل مصممة بدقة.
في المقابل، نجحت إيران سريعًا فيما يبدو في امتصاص آثار الضربة الإسرائيلية الأولى، ولإدراكها للدور الكبير للاختراقات الرقمية، فقد اتخذت عدة إجراءات دفاعية، كان أبرزها فرض قيود على استخدام الإنترنت والاتصالات وسط المستويات القيادية، بالتوازي مع تنفيذ هجمات سيبرانية وإلكترونية لمراكز القيادة والسيطرة الإسرائيلية خاصة منظومات الدفاع الجوي ونجحت في فتح ثغرات في تلك المنظومات أتاحت فرصًا لنفاذ عددٍ من هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة وضرب العمق الإسرائيلي.
كما انتشرت رسائل تحذيرية على نطاق واسع بين الإسرائيليين من أبرزها (تعليق إمدادات الوقود في المحطات لمدة 24 ساعة، والتحذير من هجوم وشيك سيقع بالقرب من أحد الملاجئ، وحث الناس على الابتعاد) بهدف إثارة الذعر وسط الضربات الصاروخية المستمرة، وصُممت الرسائل لتبدو وكأنها تحذيرات رسمية من قيادة “الجبهة الداخلية الإسرائيلية”، وفي الفترة التي سبقت الحرب، جرى الإعلان عن اختراق أجهزة الأمن الإسرائيلية والاستيلاء على “آلاف الوثائق السرية” تعود إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وتشمل معلومات عن منشآت نووية، كما كان هناك استخدام محدود لوكلائها في المنطقة ونفذت ضربات محدودة تجاه الأراضي الإسرائيلية عبر الحوثيين، مع ضربات محدودة أيضًا للقواعد الأمريكية في العراق عبر الفصائل العراقية.
وختامًا، نُشير إلى أن الحرب بين إسرائيل وإيران قد كشفت عن نمط جديد من الردع يعتمد على إحداث تكلفة استراتيجية ونفسية مرتفعة، دون الحاجة إلى امتلاك تفوق عسكري تقليدي، وأثارت أهمية امتلاك الدول بعض عناصر القوة لكسب الحروب القادمة، خاصةً فيما يتعلق بتوافر منظومة متكاملة من الدفاع متعدد الطبقات، وامتلاك قدرات إلكترونية وسيبرانية دفاعية وهجومية، وجبهة داخلية متماسكة لديها القدرة على استيعاب وامتصاص الضربات نفسيًا وإعلاميًا، إضافةً إلى إثارة مسألة مدى قدرة الردع غير المتكافئ على أن يُصبح نموذجًا مستدامًا في الصراعات الإقليمية.
[1] Paul K. Huth, “Extended deterrence and the outbreak of war”, American Political Science Review, Vol. 82, No.2. June 1988. P 423 – 443.
[2] Lawrence Freedman, “Deterrence”, Polity Press. 2004.
[3] “Deterrence Theory”, the Center for International Relations and International Security. Available at https://www.ciris.info/learningcenter/deterrence-theory/
[4] Frank G. Hoffman, “Hybrid Warfare and Challenges”, Joint Forces Quarterly. No. 52. 1st Quarter 2009. Available at https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA516871.pdf
[5] Arsalan Bilal, “Hybrid Warfare – New Threats, Complexity, and ‘Trust’ as the Antidote”, NATO Review. November 2021. Available at https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/11/30/hybrid-warfare-new-threats-complexity-and-trust-as-the-antidote/index.html